النقد ما بعد الاستعماري لفيلم «داني بوي» للمشاهد العراقي
السردية التي تصنعها الـBBC عن معركة «داني بوي» تبدو، في ظاهرها المكشوف، دراما عن بطلٍ عالقٍ في دهاليز المحكمة. جندي بريطاني (براين وود) يعود إلى منزله مكلَّلاً بوسام الشجاعة بعد معركة دموية في ميسان/الميعمارة، ثم يجد نفسه بعد سنوات أسيراً بين شتاء الأوراق القانونية وصيف الذكريات، بعدما اتّهمه فريق من المحامين الحقوقيين بتعذيب وقتل أسرى عراقيين. الفيلم، بأداء لافت من أنتوني بويل وإخراج مقتضَب من سام ميلر، يبدو «محايداً» في ظاهره: يحاول أن يُظهر وجه الجندي الغاضب، ووجه المحامي المثالي الذي يريد كشف حقيقة الحرب. لكن هذه الحياد، حين ننظر إليه بمنظار ما بعد الاستعمار، يتحوّل إلى مجال واسع من الحذف والتحريف؛ مجال يضع الذاكرة الجمعية للعراقيين من جديد في الهامش، ويختزل العنف البنيوي للاستعمار إلى نزاع شخصي. في هذا النص أحاول أن أشرح للمشاهد العراقي كيف يدفع الفيلم بهذا الحذف إلى الأمام، وكيف يمكننا ــ من خلال نقد ما بعد استعماري ــ استدعاء صوت الضحايا وملامحهم إلى داخل النص من جديد. وقد تجنّبتُ عمداً الإكثار من العناوين الفرعية للمحافظة على وحدة التدفق؛ فالهدف هو العبور المتّصل من جلد الواقعية الظاهرية للفيلم إلى عظامه الأيديولوجية.
يبدأ الفيلم منذ الدقيقة الأولى بلقطة قريبة لوجه براين وود؛ جندي يجلس في غرفة الجلوس المنزلية، تحت ضوء أصفر دافئ، يعلّق وسامه ويبادل ابنه الابتسامة. هذه الصورة العائلية هي في اللغة السينمائية الغربية استراتيجية معروفة: «أنسنة الجندي» قبل طرح السؤال الأخلاقي. ثم يقطع الفيلم سريعاً إلى ساحة المعركة: عدسة واسعة مهتزّة، صراخ «Move, move!»، وصوت الرصاص المتقطّع. إلى هذه اللحظة، لا يظهر العراق للمشاهد سوى غبار أصفر؛ صحراء بلا سكّان. أول اسم عربي يظهر يأتي على لسان الجندي: «داني بوي»؛ الاسم الرمزي الذي يطلقه الإنجليز على منطقة عراقية. ومن هنا يبدأ الاستشراق فعلياً: فالتسمية تمنح الملكية. حين تُسمّى أرض جنوب العراق باسم أغنية إيرلندية، يُمهَر في ذهن المشاهد البريطاني أن هذه الأرض بلا اسم أصلاً… وأننا نحن من نمنحها الاسم.
قد يقول قائل إن هذه التسمية هي الاسم الحقيقي للعملية، وأن الفيلم مجرد ناقل. لكن سؤال النقد ما بعد الاستعماري هو: لماذا، في إعادة الإنتاج السينمائي، لا يُبذل أي جهد لذكر اسم عربي واحد للمكان أو للقرى المحيطة؟ الجواب بسيط: صنّاع الفيلم لا يريدون للمكان أن يصبح مألوفاً لدى المتلقي الغربي؛ فالألفة تولّد التعاطف، والتعاطف يقوّض شرعية العنف. يجب أن يبقى العراق «غامضاً» كي تُفسَّر أي واقعة فيه باعتبارها «استثناءً حربياً»، لا اعتداءً على سيادة شعب له تاريخ وثقافة.
الخط السردي الثاني في الفيلم يدور في غرف لجنة التحقيق؛ حيث ينقل فيل شاينر، المحامي اليساري البريطاني، شهادات عراقيين يقولون إن جنود الملكة عذّبوا معتقلين ثم أعدموهم. لكن هذه الشهادات تُقرأ على الورق؛ فلا نرى شاهداً عراقياً، ولا نسمع صوته. العراقي، في الفيلم، يظهر على شاشة مراقبة أو خلف ستارة الترجمة. ووفق عبارة غاياتري سبيفاك، هذا بالضبط هو «خنق خطاب التابع»: فموضوع الاستعمار لا يستطيع الكلام؛ يجب على آخر أن ينطق عنه، وباللغة التي تضمن بقاء السيطرة بيد الغرب. وهكذا يتحوّل صراخ امرأة عراقية بين السواتر الترابية ــ وهو الصراخ القادر على هزّ وجدان المشاهد ــ إلى «تقرير قانوني» على لسان المحامي؛ تقرير يمكن النقاش فيه، ويمكن القبول به أو رفضه، لكنه غير قابل للمعايشة.
يحاول الفيلم، بطبيعة الحال، أن يحافظ على قدرٍ من العدالة القانونية: فنحن نرى كيف ينتهي المطاف بفين شاينر، بعد سنوات من المعارك القضائية، محروماً من مزاولة المهنة بسبب مخالفات مالية وتضخيم بعض الشهادات. يستخدم الفيلم هذه الحبكة ليُظهر نفسه «محايداً». لكن الحياد في ساحة الاستعمار، بحسب تعبير إدوارد سعيد، مجرّد وهم. فعندما يكون العراقي غائباً، يصبح سقوط شاينر ليس توازناً أخلاقياً، بل خطوة إضافية في محو الأدلة. قد يقول المشاهد البريطاني في نفسه: «إذن يبدو أن الاتهامات كانت مختلقة»، لأن الفيلم ينتهي بلقطة مقرّبة لوجه الجندي وبدموع أمه؛ وكأن المحكمة تطهّر الضمير القومي، ويمكن للتاريخ أن يُعاد كتابته بمجد الميدالية. لكن ماذا عن عائلات القتلى الذين لا نعرف أسماءهم؟ الفيلم لا يخبرنا، وبالتالي لا ينشغل المشاهد أيضاً.
في هذا الموضع يجب أن نلتفت إلى آلية «المسؤولية الفردية». يحمل الفيلم عبء الحرب على كتفي جندي واحد؛ فإما أن يكون وود مذنباً أو بريئاً. إن كان بريئاً، تبرّأ المؤسسة العسكرية؛ وإن كان مذنباً، تبرّأت أيضاً، لأن الخطأ عندها «فردي». هذه هي الاستراتيجية التي وصفها جيجك في نقد النيوليبرالية: اختزال الأزمة البنيوية في خطأ شخصي حتى لا يُطرح سؤال المنطق الاستعماري. تُنتج BBC Two بموازنة حكومية؛ والدولة البريطانية مموّل مباشر. فلا تتوقع أن يصف الفيلم، تصريحاً أو تلميحاً، غزو 2003 بأنه غير قانوني. إذن المسار البسيط هو: إمّا أن الجريمة لم تقع، أو أن الجندي فعلها من غير قصد، أو أن المحامي بالغ فيها. وهكذا يبقى العنف البنيوي خارج القفص.
نقطة أخرى مهمّة هي شكل الفيلم. يستخدم سام ميلر، المخرج، معايير «سينما الفيريتي» في إعادة تصوير المعركة: كاميرا على الكتف، فوكس طري، ضوء طبيعي. هذا الشكل الشبيه بالوثائقي يمنح فوراً «شرعية الواقع» في ذهن المشاهد؛ فيظن أن ما يراه حقيقي لأن شكله يشبه مقاطع الجنود. لكن الحقيقة تكمن في اختيار الشكل نفسه: هل نرى المشهد من زاوية الجندي، أم من زاوية الضحية؟ عندما تكون الكاميرا على كتف وود، يصبح كل عربي خلف الجدار تهديداً محتملاً. حتى لو كان أعزلاً، تقول لنا العدسة المهتزّة: «ربما يحمل قنبلة». وعندما يطلق وود النار، تكفي لقطة سريعة لوجهه المرتعب كي يقول المشاهد: كان محقّاً. الاستعمار البصري يعمل عبر الكادر أكثر مما يعمل عبر الكلمة.
لكن الفيلم يمنح المشاهد العراقي فرصة أيضاً: فرصة لقراءة كيفية «تنقية الضمير الاستعماري» داخل التلفزيون الحكومي البريطاني. هذه القراءة لا تتحوّل إلى فعل نقدي إلا إذا ملأنا نحن الفراغ الذي يتركه الفيلم. فعندما يقول وود في أحد المشاهد لابنه: «لم أضرب الأسرى قط»، تلتقط الكاميرا خلسةً ابتسامة الطفل. هذه اللحظة صُمِّمت لتمسَّ قلب المشاهد. لكن إن سمعنا في المقابل صوت أبٍ عراقي يروي كيف استلم جثة ابنه الممزّقة في مستشفى العمارة، سينقلب ميزان العاطفة. التأثير ما بعد الاستعماري يتحقّق هنا بالضبط: إدخال الصوت المُهمَل لكسر هيمنة العاطفة الموجَّهة.
من أهم مفاهيم النقد ما بعد الاستعماري فكرة «الإنسانية الاحتكارية» ــ أي من يملك حقّ الحداد العلني، ومن يُدفَن بصمت. في الفيلم نشاهد حفل تكريم وود مع عزف الفرقة العسكرية؛ علم بريطانيا في مهبّ الريح، وزوجته بدموعها. لكن لا نرى أي جنازة في العمارة. هذا الغياب ليس صدفة؛ فالرواية الغربية تعرف تماماً أنه لو ظهرت أمّ عراقية تنتحب على جثمان ابنها، لغطّى صوتها على موسيقى الأوركسترا. الاستعمار الثقافي، وفق تحليل أشيل مِمبِه، هو السيطرة على «حقّ الحِداد». «داني بوي» يحافظ على هذه السيطرة، حتى وهو يتظاهر بانتقادها.
وحتى على مستوى اللغة، يعيد الفيلم إنتاج المنظور الاستعماري. فطوال السيناريو، تُستخدم كلمات مثل «متمرّد» و«إرهابي» لوصف المقاتل المحلي، لكن كلمة «مقاوِم» أو «مناضل» لا تُسمع أبداً. اختيار المفردات هذا يبقي ذهن المتلقي الغربي داخل المدار الأمني. وفي المشهد الأخير من المحكمة، يسأل القاضي: «هل أنت متأكد أن القتلى كانوا غير مسلحين؟» يبقى جواب الجندي والمحامي في مساحة الالتباس. لكن أحداً لا يسأل: هل لقوة احتلال أصلاً شرعية في اعتقال أفراد محليين، فكيف بفتح النار عليهم؟ المنطق نفسه مبرمج من البداية داخل بنية السؤال.
من الناحية البنائية، ينجح الفيلم في إظهار الفضاء القانوني كحيّز خانق: صوت عقارب الساعة، اللقطات القريبة لقبضة الكرسي. هذه الاستراتيجية الحسيّة تجعل قلق الجندي ملموساً. لكن التقنية نفسها، في غياب قلق الضحية، تجعل من الجندي «الذات» المركزية. يصبح قلقه سبباً لتعاطف المشاهد. وعلى النقيض، لا نجد حتى لقطة مقربة واحدة لوجه أمّ عراقية. هذا التفاوت ليس بصرياً فقط، بل عاطفياً: فالاستعمار العاطفي يقوم على احتكار مساحة التعاطف.
قد يقول المدافعون عن الفيلم إن الميزانية المحدودة حالت دون السفر إلى العراق والعمل مع ممثلين عرب. هذا مبرّر اقتصادي، لكنه استمرار للصمت الثقافي. ففي زمن الإنترنت، يمكن للمخرج إدراج لقطة أرشيفية واحدة حقيقية لعائلة الضحايا؛ كما فعل صنّاع أفلام البوسنة أو رواندا. عدم الاختيار هو اختيار بحد ذاته؛ اختيار يخدم ديمومة وجهة النظر الاستعمارية.
لكن ماذا يحدث على مستوى السياسة الغربية؟
عُرض «داني بوي» على شاشة حكومية، في سنة كان البرلمان البريطاني يناقش خلالها مشروع «قانون حماية المحاربين القدامى»؛ وهو قانون يَحول ــ عملياً ــ دون ملاحقة الجنود البريطانيين على الجرائم المرتكَبة في الخارج، إلا في حالات استثنائية. يظهر الفيلم، ظاهرياً، مستقلاً عن التشريع، لكنه في لاوعيه الجماعي يمهّد الأرضية: يلمّح إلى أن الملاحقات الحقوقية غالباً ما تكون واهية، وأنها تحطّم أبطال الأمة. وبهذا تمنح الدراما ــ دون أن ترفع شعاراً سياسياً واحداً ــ غطاءً عاطفياً للسياسة الخارجية التي ما زالت تملك قواعد ومصالح في العراق والمنطقة. هنا تتجلّى «القوة الناعمة» للـBBC: تشكيل الوعي دون أي تصريح.
مع ذلك، يمتلك الفيلم نقاط ضعف يمكن اتخاذها مدخلاً للنقد. أهمّها الازدواجية التي لا تنتهي: يريد الفيلم أن يقول إن الجندي ربما أخطأ، لكنه يريد في الوقت نفسه أن يبقي الجندي محبوباً. يظهر هذا التناقض في مشهد يصرخ فيه وود في وجه المحقّق: «لقد ضحّيتُ من أجل بلدي»، وفي اللحظة نفسها ينعكس وسامه في زجاج النافذة. يقطع المونتاج إلى عيني أمّه الدامعتين، فيمنح المشهد مصادقة عاطفية. تقنياً، المشهد فعّال جداً؛ لكن من منظور ما بعد استعماري، هذه لحظة يرتدي فيها العنف البنيوي قناع الإنسانية.
وللمشاهد العراقي، قد يكون استيعاب هذه اللحظة مؤلماً؛ لأنه يرى كيف يتحوّل دمُنا إلى دمعةِ جندي. لكن مواجهة هذا الألم ليست بإطفاء شاشة التلفاز، بل بفهم الآلية التي تُصنَع بها هذه الاستعارات. فكلما قرّبت الكاميرا عدستها على رمشة وود، علينا أن نتصوّر رمشة امرأة في العمارة. وإذا أراد الفيلم منا أن نغفر، فعلينا أن نسأل: من يملك حقّ الغفران؟ من هو صاحب الجرح؟ فالغفران حقّ لأهل الضحايا، لا لقضاة لندن ولا لمشاهد الـBBC.
ولا بدّ من التوقّف أيضاً عند شخصية المحامي الحقوقي. فشاينر يظهر في بداية الفيلم ملاكاً للعدالة؛ ثم يسقط. هذا التحوّل يثري الدراما لكنه خطير سياسياً: فالمحصّلة الضمنية أن «كل ادّعاءات انتهاك حقوق الإنسان قد تكون لعبة سياسية». الفيلم لا يذكر أن سقوط شاينر ــ رغم واقعيته ــ لم يمنع الحكومة البريطانية من الاعتراف، في تقرير 2018 الرسمي، بوقوع انتهاكات وتعذيب واسع في البصرة. لكن السينما تملك ذاكرة أقوى من التقارير؛ فالمشاهد لن يقرأ تلك الوثيقة، لكنه سيتذكّر صورة المحامي المهزوم. هذه هي «قوة السرد» ــ أو ما يسميه درّيدا «القوة التي تتجاوز الحقيقة».
وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى إمكان «استعادة النص». يمكن قراءة «داني بوي» لا كحكاية بطل، بل كوثيقة: وثيقة عن كيفية تبييض الضمير القومي للمستعمِر. فإذا قرأه العراقيون بعيون نقدية، سيفهمون لماذا ــ بعد عقدين ــ لا تصل محاكمات جرائم الحرب إلى القادة السياسيين؛ لأن البنية الثقافية نفسها تطيح بالأساس الأخلاقي اللازم لتلك المحاكمات. يمكن للناقد العراقي أن يستغلّ ثغرات الفيلم: فغياب الوجه العراقي هو نقطة اختراق، ويمكن تعويضه بصناعة أفلام محلية، وبكتابة روايات ومقالات تستعيد السردية المغيّبة. يصبح الفيلم، عندها، محفّزاً لإنتاج الرواية المضادّة.
الكلمة الأخيرة:
«داني بوي» ــ رغم مهارته الفنية وأداءاته القوية ــ يبقى وريثاً لتقليد استشراقي عميق يعود إلى زمن حروب بوش وبلير، ويُعيد في قالب ميلودراما قانونية سياسةَ إسكات الضحية. إنّ السياسة التي «حرّرت» العراق عام 2003 تقدّم لنا اليوم سرديةً يكون فيها صوت الحرية للجندي، أما صوت المقتولين فيُدفَن في الصمت. فإذا أراد المشاهد العراقي قلب هذه السردية، فلا بدّ من تدمير الصمت: بسؤال الأسماء، بعرض الوجوه، وبإحياء الذكريات باللهجة العراقية. عندها فقط تتحوّل أفلام الـBBC من بلسم للضمير البريطاني إلى مرآة تعكس العنف الذي ما زال يتنفّس في أزقّة البصرة وميسان.
على مستوى السرد، يصل الفيلم خطّين زمنيين ببعضهما: مشاهد إعادة تمثيل معركة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٤ قرب العمارة، وجلسات لجنة تقصّي الحقائق (٢٠٠٩–٢٠١٤) التي تُعقد في أجواء متوتّرة بحضور المحامي الحقوقي فيل شاينر. المونتاج المتوازي يُبقي البطل معلّقاً بين كبرياء البزّة العسكرية وذلّ البزّة الرسمية في المحكمة؛ وهذا التذبذب هو العامل الرئيس في صناعة التعليق النفسي للفيلم. يستخدم ميلر في مشاهد ساحة المعركة عدسات واسعة مهتزّة، وضوء النهار القاسي، وطبقة لونية ترابية مائلة إلى الأخضر، لإحياء ذاكرة مقاطع «كاميرا الخوذة» التي صوّرها الجنود؛ في المقابل، تدور جلسات الاستجواب في استوديو ذي جدران رمادية-خضراء وإضاءة فلوريسنت مسطّحة لتوليد إحساس بالبرد والخمول البيروقراطي.
أداء أنتوني بويل في دور براين وود هو العمود الفقري للعمل: وجه طفولي مع شارب بالكاد نما، وعينان ترتجفان بين الإنكار والبكاء، وجسدٌ يعود فجأة، أثناء إعادة تمثيل الهجوم، إلى ذاكرة «بطل يحمل وثيقة شجاعته». في مواجهته يقف توبي جونز بدور فيل شاينر، مزيجاً من الأخلاقية والطموح؛ رجلٌ يريد تمزيق السردية الرسمية للجيش لكنه ينهار داخل شقوق النظام القانوني نفسه. اختيار جونز لم يكن لأجل بناء الشخصية فحسب، بل لتحقيق توازن في الشهرة: فالمشاهد يثق بجونز مسبقاً وبالتالي يمنحُ الحقّ للمحامي في الدقائق الأولى من الفيلم؛ ثم عندما يبدأ الملفّ بالتفكك ضمن طبقات عملية «أل-سويدي»، تدخل هذه الثقة نفسها في أزمة.
يحوِّل «داني بوي» خلال ٨٤ دقيقة واحدة من أعقد العُقَد الأخلاقية في الجيش البريطاني أثناء حرب العراق إلى دراما قائمة على غرفة التحقيق وقاعة المحكمة: فطريق تحوّل الجندي إلى «بطل» يمرّ من قلب تهمة «ارتكاب جريمة حرب». يركّز الفيلم التلفزيوني، من إخراج سام ميلر وسيناريو روبرت جونز، على حياة براين وود، قائد الفصيلة الأولى من فوج أميرة ويلز؛ ذاك الذي نال وسام «صليب الشجاعة» بسبب هجومه بالحراب في معركة «داني بوي»، ثم وجد نفسه بعد خمس سنوات تحت ظلال تحقيق «أل-سويدي» متَّهماً بتعذيب وقتل أسرى عراقيين. )
ظروف الإنتاج: قامت شركة Expectation بإنتاج الفيلم لصالح BBC Two خلال جائحة كوفيد، وبميزانية محدودة؛ نُفِّذ القسم الأكبر من التصوير في استوديوهات ويلز وميادين التدريب في «ساندينغ بينغز»، حيث جرى باستخدام CGI minimal إعادة خلق البيئة الصحراوية لجنوب العراق. وقد أدّى حضور مستشارين عسكريين، من بينهم براين وود نفسه، إلى جعل الحركات العسكرية ــ من التعليمات اللاسلكية إلى زاوية نظر القنّاص على التل ــ دقيقة؛ لكن قيود السفر فرضت استخدام ممثلين ثانويين غير شرقيين في مشاهد المعركة لتجسيد «جندي/مقاتل عراقي» في اللقطات البعيدة. هذا الغياب يشكّل نموذجاً للمشكلة التي يحاول الفيلم نقدها: حتى في ساحة الإنتاج، يغيب العراقيون.
الفيلم من حيث البناء عملٌ يعتمد بعمق على الحوار. فالقاضي، بملامحه الصارمة، يكرّر الأسئلة الدقيقة بنبرة هادئة، فيما تتركّز الكاميرا على ردود الفعل الميكروسكوبية لبويل. ومن منظور الميزانسين، لا يوجد على طاولة المحكمة سوى كأس ماء وقلم رصاص؛ علامة على خواء ساحة المعركة القانونية بالنسبة لجندي اعتاد حمل السلاح. هذا الفراغ يضاعف قفر الروح داخل الشخصية.
الحلقة الموضوعاتية: الخط الرفيع بين «العنف المشروع» و«الجريمة». يتر intentionally يترك السيناريو فجوة في إعادة مشهد قتل الأسرى المفترض: لا نرى أبداً صورة واضحة عمّا وقع خلف الساتر الترابي؛ نسمع فقط أنفاس وود المتقطّعة داخل كادر مهتز. هذا الحذف يستحضر مفهوم «اللامقال الضروري» عند جيجك: فالفيلم لا يستطيع أن يحدّد ما هي الحقيقة، بل يعرض ارتباك البنية القانونية ذاتها.
الجوانب الإيجابية:
١. الأداء المزدوج لبويل وجونز، اللذين يعملان كمرآة أخلاقية متقابلة.
٢. الاستخدام الخلّاق لدرجتين لونيّتين لتمييز ميدان الحرب عن ميدان القانون.
٣. الفصاحة في ضغط عشر سنوات من التحقيق داخل ٨٤ دقيقة دون هبوط في الإيقاع.
٤. معالجة أزمة ما بعد الحرب لدى الجندي؛ فـوود يرتجف من اضطراب ما بعد الصدمة، لكنه لا يصرخ، بل يرمش فقط… وهذه الرمشات معقّدة.
الجوانب السلبية:
أ) حذف وجهة النظر العراقية. لا يظهر أي شاهد عراقي حيّ في الكادر؛ تُقرأ الشهادات على الورق. بالنسبة لفيلم يدّعي البحث عن الحقيقة، يمثّل هذا الغياب استمراراً لـ«محو الآخر» في الإعلام الغربي.
ب) الميل إلى تبرئة المؤسسة العسكرية: فالنهاية تُظهر انتصار براين في ردهة المحكمة؛ فيثقل شعور النشوة البطولية، وتُختزل خطيئة الحرب البنيوية في مستوى الفرد.
ج) القيود الميزانية والمواقع المغلقة جعلت بعض اللحظات تبدو أقرب إلى لوحات مسرحية؛ فمثلاً يُعرَض انفجار العبوة الناسفة عبر اهتزاز الكاميرا وارتفاع الصوت فقط.
د) بناء شخصية شاينر يبقى ضئيلاً: فدوافعه الأيديولوجية، ولاسيما سقوطه لاحقاً (قضايا الفساد المالي والمهني بعد الملف)، لا تظهر إلا في سطور قليلة خلال التترات الختامية.
النتيجة:
«داني بوي» وثيقة عن التحليل النفسي لجيشٍ بأكمله؛ يُظهر كيف تأتي الحرب، وتصنع بطلاً، ثم تسحبه إلى غرفة المحاكمة. غير أن الفيلم يبقى أسير المنظور نفسه الذي ينتقده: حقيقة الضحية العراقية تبقى في الهامش. وعلى المشاهد الناطق بالفارسية، إن أراد قراءة مكتملة، أن يحسب هذا الفراغ على الإعلام وأن يقرأ الحكاية غير المكتوبة إلى جانب الصورة. ومع ذلك، يظلّ الفيلم ــ بفضل الأداءات الحادّة والمونتاج الثنائي ــ نموذجاً قوياً لـ«دراما محاكمات الحرب» في التلفزيون البريطاني، يحفظ إمكانية النقاش حول المسؤولية الأخلاقية للجنود، وواجب المحامين الحقوقيين، والكلفة السياسية للتدخل في الشرق الأوسط.




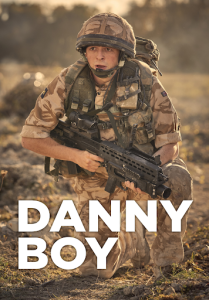

كن أول من ينشر تعليقًا.
آراء المستخدمين