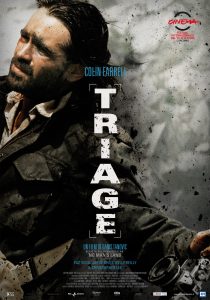
المخلص إذا كنت قد نشأت في العراق، فغالبًا ما واجهت أفلام حربٍ ينقل فيها الغرب كوارث بلدك بعدسة كاميراه. فيلم «الفرز» للمخرج دانيس تانوفيتش هو أحد هذه الأعمال: قصة مصوّر صحفي إيرلندي يعود جريحًا ومضطربًا إلى دبلن بعد مهمة في كردستان العراق عام 1988.
النقد ما بعد الاستعماري لفيلم «الفرز» (Triage، 2009)
الكشف عن النظرة الاستعمارية تجاه العراق
١. مركزية المعاناة الأوروبية
فيلم تدور أحداثه في صلب واحدة من أحلك فصول الشرق الأوسط، لكنه يضع معاناة مصوّر إيرلندي في المركز.
عندما تخترق رصاصة بعثية جسد مقاتل كردي، تُركّز الكاميرا على تعبير مارك، لا على شفتَي الجريح اللتين قد تنطقان بكلمات أخيرة لأمه.
هذا هو الاستعمار البصري: الآخر لا يُرى إلا كخلفية لمعاناة الأنا.
٢. إسكات الشعوب المحلية
لا تُسمع جملة طويلة واحدة بالكردية أو العربية.
حتى الطبيب تالزاني يتحدث الإنجليزية، وكأن اللغة الأصلية مزعجة للسرد الغربي.
حذف اللغة الأصلية هو نمط كلاسيكي من “الاستشراق” كما وصفه إدوارد سعيد:
يجب أن يبقى الشرق صامتًا كي يرويه الغرب.
٣. نقل الجغرافيا، حذف الأرض الحقيقية
التصوير في إسبانيا وإيرلندا يحمل رسالة ضمنية:
«لا حاجة لنا بالذهاب إلى العراق لصنع فيلم عنه؛ أي جبل في المتوسط يكفي».
هذا التهميش للمكان هو امتداد لتقليد استعماري يعيد رسم خريطة العالم وفق حاجات الصورة.
٤. السرد الأخلاقي المزدوج
مارك، رغم تصويره لعمليات “قتل رحيم”، يُقدّم كبطل متعاطف؛
المشاهد يُفترض أن يتفهّم أنه “لا يتحمل الصدمة”.
لكن الجندي العراقي أو الكردي، الذي ربما تعرّض للتعذيب لسنوات، لا يُمنح حتى فرصة لبناء شخصية.
هذه الازدواجية تُعيد إنتاج نظام القيم الاستعماري:
«معاناتنا معقّدة؛ معاناتكم خلفية».
٥. محو التاريخ السياسي
عام 1988 هو عام ذروة عمليات الأنفال والقصف الكيميائي.
الفيلم لا يذكر اسم صدام أو حلبجة؛ لأن هذه الأسماء تفتح أبوابًا خطيرة:
أسئلة حول الدعم الغربي السري للنظام البعثي.
محو التاريخ يعني محو المسؤولية.
٦. استهلاك صور العنف للسوق الغربي
مشاهد إطلاق النار على الجرحى والانفجارات صُممت لصدم المشاهد، لا لاستثارة تعاطفه مع الضحايا.
الصورة تتحول إلى سلعة تثير مشاعر الغرب وتُغني جيب المنتج؛
هذا هو “اقتصاد العواطف” في الإعلام الاستعماري.
٧. علاج غربي لشفاء حرب شرقية
ذروة الفيلم هي جلسة التحليل النفسي؛ تحليل نفسي متمركز على أوروبا، ينتهي بتطهير ذاتي فردي.
لا نرى عدالة انتقالية جماعية، أو محاكم، أو حتى ذكرى إبادة الأكراد.
السرد الاستعماري يُحلّ المشكلة على مستوى نفسية الأبيض ويترك المأساة الحقيقية معلّقة.
٨. الفلتر اللوني ودرجة الحرارة البصرية
كردستان مصوّرة بفلتر أصفر/برتقالي حار (الشرق المهدِّد)،
ودبلن بفلتر أزرق/رمادي بارد (الغرب المنظّم).
هذا الترميز اللوني اللاواعي يخبر المُشاهد بأن الحرارة = خطر، والبرودة = حضارة؛
نفس اللغة البصرية التي تتكرر في أفلام استعمارية من شمال إفريقيا إلى غرب آسيا.
٩. غياب المرأة العراقية
لا نرى امرأة كردية طوال السرد، ولا أمهات يُخرجن أطفالًا من تحت الأنقاض.
في المقابل، تُمنح المرأة الغربية (إلينا وديان) حضورًا بارزًا؛
الدراما محمولة على أكتافهنّ المبلّلة بالدموع.
غياب النساء المحليات هو تغييب لنصف الحقيقة.
١٠. خلاصة القراءة ما بعد الاستعمارية
تُظهر القراءة ما بعد الاستعمارية لفيلم «الفرز» أنه – رغم مظهره المناهض للحرب – يعيد إنتاج منطق الاستعمار الثقافي.
أولًا، بطل القصة رجل أبيض من الغرب؛
هو الذي يتألم، يعود إلى الديار، ويجب أن يبقى في مركز الاهتمام ليتعافى.
ثانيًا، الضحايا النشطون لا وجود لهم؛
الكُرد والعراقيون يسقطون في لقطات مهتزة أو لا يتكلمون على الإطلاق، ولا يمتلكون أي إرادة سردية.
ثالثًا، يتم نقل المركز السردي من جبال العراق إلى غرفة المعيشة في دبلن؛
أي أن أزمة الشرق الأوسط الكبرى تُختزَل داخل راحة الغرب.
رابعًا، يُمحى التاريخ السياسي: لا ذكر للأنفال، حلبجة، أو دعم الغرب لصدام، لئلا يُجبر المشاهد على اتخاذ موقف أخلاقي.
وأخيرًا، التقنية البصرية تُكرّس ازدواجية الشرق الحار/الغرب البارد؛
فلتر أصفر لكردستان، وأزرق ورمادي لإيرلندا.
والنتيجة أن «الفرز» يبدو كفيلم ينتقد الحالة النفسية، لكنه في الواقع يستخدم معاناة الشرق وقودًا لهوية الغرب وتراجيدياه.
الخاتمة
«الفرز» يحذّر ظاهريًا من أن الحرب تُدمّر الروح البشرية؛
لكن هذا التحذير ملفوف داخل غلاف من السرد الاستعماري.
الفيلم يُضخّم ألم الرجل الأبيض بدل أن يعكس صوت العراق،
ويمحو التاريخ ليُزيل المسؤولية السياسية.
بالنسبة لنا كعراقيين، فإن مشاهدة هذا الفيلم ليست نهاية للنقاش، بل بداية لسؤال:
«كيف نستعيد قصتنا؟»
في استعادة الصورة والرواية، يُضعف الاستعمار الثقافي، وتظهر حقيقةٌ متعددة الأصوات.
يبدو الفيلم للوهلة الأولى سردًا لمعاناة شخصية أوروبية، لكن تحت هذا الغلاف النفسي تكمن سردية تُقلِّص العراق وشعبه إلى «خلفية».
هذا النقد يسير مع الفيلم خطوة بخطوة ليُبيّن كيف أن الاستعمار السردي لا يزال فاعلاً في السينما الغربية.
تقديم موجز للفيلم
«الفرز» (Triage، 2009) هو أحدث فيلم طويل للمخرج البوسني الحائز على الأوسكار دانيس تانوفيتش، وهو مقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه كتبها الصحفي الحربي الأمريكي سكوت أندرسون.
تدور القصة حول مارك والش، المصور الصحفي الإيرلندي، ويؤدي البطولة كلٌ من كولين فاريل، باز فيغا، كريستوفر لي، جيمي سيفز وبرانكو دوريتش.
مدة الفيلم تقارب 100 دقيقة، ويُقدَّم بشكل رئيسي باللغة الإنجليزية، مع جُمل قصيرة بالكردية والإسبانية لتعزيز الإحساس بجغرافيا متعددة.
رغم أن ميزانيته لم تُعلَن رسميًا، إلا أن إيراداته العالمية لم تتجاوز 600 ألف دولار، وهو فشل تجاري، إلى جانب نقدٍ فاتر تلقّاه في مهرجان تورنتو، مما جعل عرضه محدودًا.
تم تصوير جميع المشاهد المتعلقة بشمال العراق في استوديوهات “سيوداد دي لا لوس” في مدينة أليكانتي الإسبانية وجبالها المحيطة؛ أما مشاهد دبلن فتم تصويرها في مواقع حقيقية في إيرلندا.
هذا التبديل الجغرافي المتعمد يمنح الفيلم منذ بدايته إحساس “إعادة بناء العراق في البحر الأبيض المتوسط”، ويختزل أرض العراق إلى خلفية قابلة للاستبدال ببضع صخور وغبار.
عُرض الفيلم للمرة الأولى في سبتمبر 2009 في مهرجان تورنتو السينمائي، وهناك قوبل بردود فعل باهتة؛ وكان السبب الرئيسي هو السرد السطحي والحوار “المفرط في التفسير”.
السرد الكامل للفيلم
١. الدخول إلى كردستان (ربيع 1988)
مارك والش وصديقه المقرّب ديفيد هما مصوران صحفيان يتنقلان من حرب إلى حرب.
يتوجهان إلى الجبال شمال العراق لتوثيق عمليات الجيش البعثي في المنطقة الكردية.
منذ بداية الرحلة، يستخدم الفيلم لقطات واسعة للصخور وخطوط الجبال والقرى الحجرية، ليخلق فضاءً “مجهول الهوية”، كأن كردستان مجرد نقطة على خريطة، لا جغرافيا حية يسكنها أناس حقيقيون.
٢. العيادة الميدانية و«طبيب الموت»
يصل مارك وديفيد إلى عيادة نائية.
الدكتور تالزاني (برانكو دوريتش) يُضطر إلى قتل الجرحى الذين لا أمل في نجاتهم بإطلاق النار عليهم؛
مصطلح «الفرز» (Triage) يشير تحديدًا إلى هذا الفرز بين الموت والحياة.
مارك يلتقط صورًا لهذه المشاهد؛ الإطارات مشبعة بالغبار والضوء الأصفر لإبراز العنف.
٣. الرغبة في العودة
يقرر ديفيد، الذي تنتظر زوجته الحامل في دبلن، مغادرة المعسكر.
أما مارك، المفتون بـ«إثارة الحرب»، فيُصر على البقاء بضعة أيام.
يتشكل هنا تمايز دقيق بين نظرتين: ديفيد يريد العودة إلى الحياة، ومارك يسعى لـ”صيد قصة كبيرة” ــ استعارة عن الصحافة الغربية التي تستغل معاناة الشرق كمادة خام لشهرتها.
٤. القصف المدفعي والمأساة
في طريق العودة، يبدأ قصف مدفعي من الجيش البعثي.
يفقد ديفيد ساقيه؛
في مشهد طويل، يحاول مارك إنقاذه ويربطه بحبل، لكنه يسقط في منحدر نهري ويفقده.
يُخفي الفيلم حقيقة هذا الفراق حتى النهاية ليصنع توترًا دراميًا.
٥. عودة مارك إلى دبلن
بعد أسبوع، يعود مارك إلى منزله بجسدٍ منهك ونفسٍ مضطربة.
زوجته إلينا (باز فيغا) تصاب بالذعر: مارك نحيل، صامت، لا ينام؛ ولا أخبار عن ديفيد.
هنا ينفصل الفيلم عن واقع الحرب ويتحوّل إلى غرفة جلوس أوروبية؛
النقطة التي تشعر فيها الكاميرا بالأمان.
٦. الجد المحلل النفسي
تلجأ إلينا إلى جدها الإسباني، خواكين (كريستوفر لي)، الذي عالج جنود فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية ويُعتبر خبيرًا في صدمات الحرب.
لقاء خواكين مع مارك يشكّل العمود الفقري للدراما النفسية في الفيلم.
المشاهد الطويلة من الحوار تُفعّل فلاشباكات قصيرة إلى كردستان.
٧. انكشاف السر
من خلال أسئلة خواكين المتكررة، تظهر ذكرى النهر:
يعترف مارك بأن ديفيد ترجّاه أن يُطلق عليه رصاصة رحمة، لكنه لم يملك الشجاعة؛
ثم جرفه النهر.
عبء الذنب لا ينبع من القتل، بل من “عدم إعادة الجثة”.
وهذا التركيز العاطفي يعكس مجددًا الانشغال الأوروبي: كرامة موتاهم، لا مصير مئات الأكراد المجهولين.
٨. الولادة، الموت، والجملة الختامية
تلد زوجة ديفيد في نفس ليلة الاعتراف.
يذهب مارك إلى المستشفى، لكنه لا يستطيع إخبارها بالحقيقة، ويتوجّه إلى السطح ربما لينتحر؛
لكنه يجد السلوى في حضن إلينا وخواكين.
ينتهي الفيلم بالجملة الشهيرة: «فقط الموتى يرون نهاية الحرب» ــ جملة تُنسب غالبًا إلى أفلاطون، لكنها في الحقيقة للكاتب جورج سانتيانا.
تحت سطح الإنتاج: من صفحة الرواية إلى شاشة السينما
المصدر الأدبي والسيناريو
كتب الصحفي الأمريكي سكوت أندرسون رواية Triage استنادًا إلى تجاربه في مناطق النزاع.
تولى دانيس تانوفيتش بنفسه كتابة السيناريو ليجسّد «التعقيد الأخلاقي للحرب».
لكن خلال الانتقال من النص إلى الصورة، ضَعُف البعد الصحفي القوي في الرواية، واختُزل إلى تصوير اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) الفردي.
المخرج: دانيس تانوفيتش
سبق أن أثبت قدرته في «أرض لا أحد» على نقد تراجيديا البلقان بسخرية سوداء.
لكن في «الفرز»، تتسبّب جغرافيا كردستان الغريبة ودبلن المترفة في اختلال توازنه؛
والنتيجة: فيلم منقسم ــ أول 30 دقيقة نابضة، والـ70 التالية بطيئة وحوارية.
التصوير والمواقع
كان يجب تسجيل صدمة الحرب بصريًا في بغداد أو أربيل؛
لكن جميع مشاهد العراق صُوّرت في استوديوهات «سيوداد دي لا لوس» الإسبانية وجبال أليكانتي.
غياب أي مشهد حقيقي من أرض العراق، يختم على الفيلم منذ البداية بختم «اللا مكان».
الممثلون
كولين فاريل: خسر ما يصل إلى 15 كيلوغرامًا من وزنه لأداء الدور؛ وجهه العظميّ يُجسّد الإنهاك النفسي الذي تخلّفه الحرب.
باز فيغا: دورها محدود؛ تمضي معظم وقتها في النظر والبكاء.
كريستوفر لي: حضوره ثقيل، لكن حواراته تُشبه الخُطب أكثر من كونها تفاعلاً دراميًا.
الموسيقى وتصميم المشاهد
الموضوع الموسيقي الرئيسي يعتمد على أوتار بسيطة (minimal strings) لتسليط الضوء على كآبة مارك.
الألوان في دبلن يغلب عليها الأزرق والرمادي؛
أما كردستان الصحراوية فتُقدَّم بفلتر أصفر وبرتقالي – مما يعكس الثنائية الاستعمارية “البيت الأوروبي البارد / الشرق المتوهّج”.
الاستقبال النقدي
وجّهت هوليوود ريبورتر نقدًا للفيلم بسبب “حواراته التفسيرية الزائدة” و”زاوية نظره المحدودة”.
كما أن الجمهور العام لم يتعرف عليه كثيرًا بسبب عرضه المحدود وتوزيعه المنزلي.
نقاط القوة والضعف السينمائي
نقاط القوة
جسد كولين فاريل التمثيلي: نحافته الشديدة، كتفاه المنخفضتان، وحركاته العصبية تُجسّد اضطراب ما بعد الصدمة بشكل ملموس.
النصف ساعة الأولى: إيقاع سريع، لقطات توثيقية خانقة؛ تمنح إحساسًا بأجواء وثائقيات الجبهة الأمامية.
مفهوم “الفرز” (Triage): يُظهر كيف تُخضع الحرب حتى الأخلاقيات الطبية للتشكيك.
نقاط الضعف
نهاية متوقعة: من منتصف الفيلم يتّضح أن سرّ مارك يتمحور حول “وفاة ديفيد”.
حوارات خطابية: خواكين لا يُمارس العلاج بقدر ما يُلقي مونوغراف عن الحرب الأهلية الإسبانية.
غياب الشخصيات الكردية: أبرز ثغرة؛ يظهرون فقط من بعيد أو يموتون سريعًا.
غياب السياق التاريخي: لا ذكر للأنفال، أو قصف حلبجة، أو دعم القوى الغربية لنظام البعث.

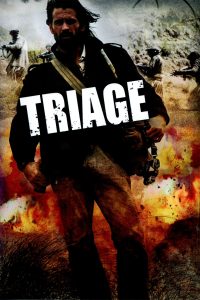





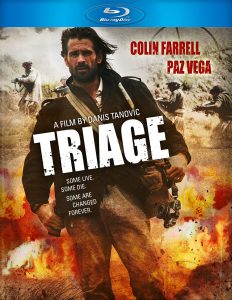

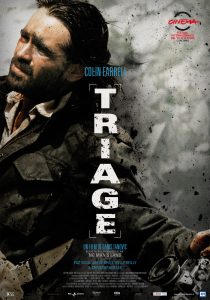




كن أول من ينشر تعليقًا.
آراء المستخدمين